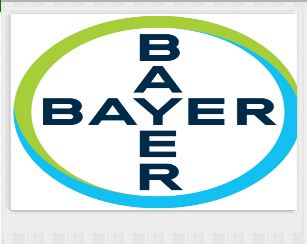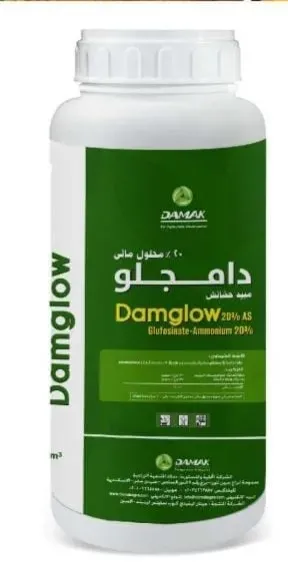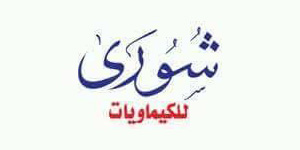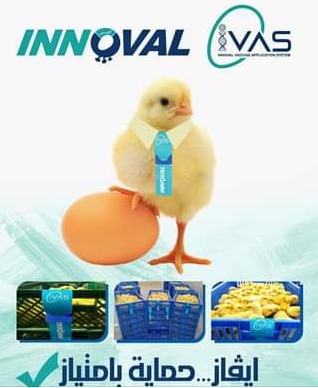خطة متكاملة لزراعة ناجحة باستخدام السماد العضوي

أكد المهندس معاوية إبراهيم استشاري الزراعة، أن الأسمدة العضوية ليست مجرد وسيلة تغذية للتربة، بل تُعد ركيزة أساسية لصحة النبات واستدامة المحاصيل، إذا ما استُخدمت بالشكل الصحيح وفي التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن الكثير من المزارعين لا يدركون الإمكانيات الهائلة التي توفرها هذه الأسمدة في تحسين جودة التربة، وتعزيز مقاومة النباتات للأمراض، ورفع كفاءة الامتصاص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الإنتاجية وجودة الثمار.
ما هو السماد العضوي؟
يتم إنتاج السماد العضوي من خلال معالجة مخلفات الحيوانات، والطيور، والنباتات، بما يضمن التخلص من بذور الأعشاب الضارة، والفطريات، والكائنات الدقيقة التي قد تضر التربة أو النبات.
توقيت الاستخدام
عادةً ما تُضاف الأسمدة العضوية في نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، ويفضّل دمجها مع الأسمدة الفسفورية مثل السوبر فوسفات الأحادي أو الثلاثي، للحصول على أفضل نتائج ممكنة.
فوائد السماد العضوي للتربة والنبات:
ولفت إلى أن إمداد التربة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين، الفوسفور، والبوتاسيوم، مما يعالج مشكلة بطء النمو لدى بعض النباتات.
فعالية طويلة الأمد، حيث تبقى العناصر متاحة للتربة والنبات لفترات قد تمتد لعام كامل.
تحسين خواص التربة، إذ يساعد في التخلص من الرطوبة الزائدة خاصة في التربة الطينية، ويُحسّن التهوية مع الحفاظ على الرطوبة اللازمة.
غني بالعناصر الدقيقة مثل الحديد، الزنك، النحاس، البورون والمنغنيز، والتي تعالج مشاكل نقص العناصر الناتجة عن نشاط الميكروبات الضارة.
تعزيز الكائنات الدقيقة النافعة التي تقاوم الفطريات والبكتيريا الضارة وتدعم النمو السليم للنبات.
تطهير التربة من الآفات الزراعية بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والإنزيمات الطبيعية.
امتصاص المواد السامة مثل الرصاص، الذي يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.
وشدد المهندس معاوية على أن السماد العضوي يُعتبر مخصبًا ومعالجًا للتربة بامتياز، إذا تم استخدامه بالكميات المناسبة وبتكرار منتظم (سنويًا أو مرة كل عامين)، خصوصًا عند مزجه بـ الكبريت الزراعي والسماد الفسفوري في أواخر الخريف، وقبل بدء موسم الزراعة.
نصائح زراعية مهمة لحماية الأشجار وتحقيق أعلى إنتاجية:
1. العناصر التخزينية (الزنك والبورون):
رشّها في أواخر الخريف، منتصف الشتاء وبداية الربيع يحافظ على المجموع الزهري ويساعد على تثبيت العقد.
2. التقليم الفني:
يضمن تجديد الفروع، ويقلل من إصابات ذبابة الفاكهة. يجب تعقيم أدوات التقليم والتخلص من بقايا التقليم بالحرق.
3. مكافحة الحلزون:
باستخدام حبوب الميتالدهيد مساءً، حيث يكون نشاطه في ذروته.
4. رش الزيت المعدني الشتوي والمحاليل النحاسية:
يحمي من الفطريات ويمنع ظهور الآفات الحشرية المرتبطة بها.
5. سلفات البوتاسيوم قبل التزهير بثلاثة أسابيع:
يحسّن امتصاص العناصر الغذائية ويضمن توزيعها بشكل متوازن.
6. تقنين الري وقت التزهير:
بسقاية مخففة (1 إلى 20 من سقاية الصيف) لتفادي ذبول الزهر أثناء الرياح الشرقية.
7. رش المنكوزيب في نهاية الربيع:
يحمي العقد الجديد من الفطريات بعد تساقط بتلات الأزهار.
8. التسميد التدريجي بالنيتروجين والحديد:
بنسبة 50% بين وجبتين يفصل بينهما شهر، لتجنب الإجهاد المفاجئ للنبات عند الانتقال إلى الصيف.
9. انتظام الري صيفًا حسب المناخ المحلي:
تفادي العشوائية في السقاية أمر ضروري لتوازن النبات.
10. حمض الهيوميك أسيد:
يُضاف للأشجار التي لا تتجاوب مع باقي العناصر، لتحفيز النشاط الحيوي في التربة.
11. رش العناصر الصغرى (مرتين إلى ثلاث خلال الصيف):
في الصباح أو المساء وبعد الري، لتعزيز مناعة النبات.
12. إضافة اليوريا فوسفيت مع بداية سبتمبر:
لتحسين توازن النمو وتقوية النبات قبل الخريف.
13. التركيز على المناعة الذاتية للنبات:
وعدم الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية، فالاعتماد الزائد يضعف مقاومة الأشجار.
14. سوء الخدمة يؤدي لرداءة الإنتاج:
قلة استخدام الأسمدة العضوية والفسفورية، وضعف الري في الصيف، سبب رئيسي لتدني جودة الثمار وعدم القدرة على المنافسة في السوق.
15. التخلص من الأعشاب الضارة باستمرار:
يفضل استخدام الحش اليدوي أو المبيدات أو التناوب بينهما، دون الحاجة لاستخدام التراكتور لتفادي إضرار التربة والشجر.


.jpg)