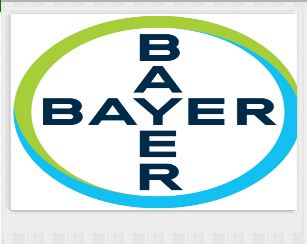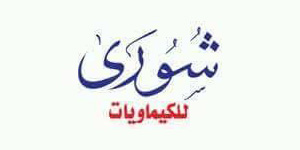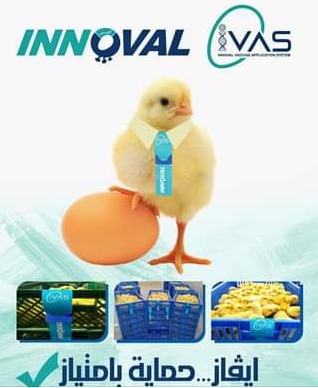هل نعيش في عصر «العلم الكاذب» في الزراعة؟*

تساؤلات حول منظمات نمو الأشجار وبرامج التغذية المكثفة
1. هل يمكن للعلم أن يُوظَّف بطريقة مضللة؟
قرأت مؤخرًا نقاشًا مثمرًا حول أحد أجهزة تحلية مياه الري، تضمن آراء أكاديمية وملاحظات من مزارعين، انتهى معظمها إلى نتيجة مفادها أن الجهاز - رغم انطلاقه من بديهيات علمية صحيحة - جاءت نتائجه شبه معدومة. هل يشير هذا إلى وجود نماذج من “العلم الكاذب” في الزراعة؟ وهل ما يُسوق باعتباره "ابتكارًا" يمكن أن يكون أحيانًا تضليلاً علميًا؟
2. هل يؤدي الإفراط في برامج التسميد ومنظمات التزهير إلى نتائج عكسية؟
لاحظ كثير من مزارعي الزيتون أن التوسع في استخدام المغذيات الكيميائية والمنظمات لم يسفر عن زيادة في الإنتاجية أو جودة الثمار أو نسبة استخلاص الزيت، بل تزامن مع تراجع ملحوظ في المحصول.
فهل التغذية الزائدة قد تتسبب في خلل فسيولوجي يعطل جهاز مناعة الأشجار ويضعف وظائفها الحيوية؟ وهل هناك دراسات مستقلة تقارن بين الإنتاج في ظل هذه البرامج، والإنتاج الطبيعي غير المحمل بمغذيات اصطناعية؟
3. هل تُفرض "العلمية" الزراعية على دول العالم الثالث من خلال سطوة الشركات الكبرى؟
تشير ملاحظات وتجارب سابقة إلى أن مناهج التعليم الزراعي في بعض البلدان تأثرت بمصالح الشركات المنتجة للأسمدة والمبيدات.
فهل هناك تدخل من هذه الشركات في رسم السياسات التعليمية والبحثية لفرض منتجاتها على السوق؟ وهل تتحول "التوصيات الفنية" في النهاية إلى أدوات تسويقية أكثر منها أدوات علمية خالصة؟
4. إلى أي مدى تختلف المنتجات الزراعية المخصصة للعالم الثالث عن تلك المستخدمة في الدول المتقدمة؟
تشير بيانات الأرباح إلى أن 75٪ من أرباح كبرى شركات الأسمدة ومنظمات النمو تتحقق من أفرعها في آسيا وأفريقيا.
هل تختلف تركيبة أو فاعلية هذه المنتجات مقارنةً بما يُستخدم في أسواق أوروبا وأمريكا؟ وهل هناك شفافية كافية في تقييم سلامتها وجدواها البيئية والاقتصادية؟
5. ما هي الحدود الفاصلة بين البحث العلمي النزيه، والبحث الموجه تجاريًا؟
في حالات عديدة، يتلاقى العلم مع المصالح الاقتصادية. فهل يمكن التمييز دائمًا بين المعرفة الصادقة التي تستند إلى التجريب النزيه، وتلك التي صُممت لتمرير منتج أو فكرة تخدم هدفًا تجاريًا؟ وما آليات حماية الأبحاث الزراعية في الدول النامية من هذا التداخل؟
6. هل نحتاج إلى إعادة تعريف "الكفاءة الزراعية" بناءً على الخبرة الحسية لا التوصيات الورقية؟
ينبه الفيلسوف كارل بوبر إلى خطورة "العلم الذي يتصادم مع الخبرة العملية".
فهل آن الأوان لنُعيد تقييم البرامج الزراعية بناءً على نتائج الحقول وليس فقط بناءً على النشرات الإرشادية؟
7. هل يمكن أن تكون الزراعة في العالم الثالث رهينة دائمة للمنتجات الغربية؟
في ضوء الملاحظات السابقة، هل تحولت بساتين الزيتون والموالح والنخيل في بلادنا إلى زبائن دائمين لشركات تصدّر العلم المدفوع بالسوق؟ وهل نحن بحاجة إلى فكر زراعي مستقل يعيد الاعتبار لخصائص التربة والمناخ والنبات المحلي؟
نقاش مفتوح لأهل العلم
هذه التساؤلات لا تستهدف التشكيك في قيمة البحث العلمي الزراعي، بل تهدف إلى الدفاع عنه من كل ما قد يشوبه من تسييس أو تسليع.
فهل نمتلك نحن، كباحثين ومزارعين وصحفيين، الشجاعة الكافية لطرح هذه الأسئلة والبحث عن إجابات موضوعية بعيدًا عن الضغوط التسويقية أو الأيديولوجية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بقلم: محمد البرغوثي – كاتب صحفي


.jpg)